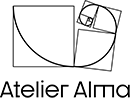بقلم آلما سالم
في الثامن من كانون الأول، ديسمبر 2024، تحطّمت التماثيل، انهارت جدران الطغيان وفتحت أبواب سجون الظلم ، وتحولت همسات الثورة—التي ترددت في العتمة، ورُسمت على واجهات مهدمة، وحملتها الأقدام المغبرة في المنافي —إلى نشيد سوريا المحررة. لم يكن سقوط 54 عامًا من حكم الأسديين مجرّد نهايةٍ لدكتاتورية، بل كان استعادةً للأنفاس، للمكان، للصوت. لقد كان بعثًا لأمة معذّبة حُرمت طويلًا من حقّها في التخّيل بحرية، وحقّها في الحياة.
على مدى أكثر من عقد، حملتُ التنسيق الفني كفعل مقاومة، وأوجدتُ فضاءات لم تكن مجرد معارض، بل كانت مواقعاً للتمرّد، واسترداداتٍ جذرية حيث تحدّى فيها الفن الإختفاء، ورفض المنفى أن يكون مرثية.
لم تسعَ ممارستي الفنية إلى حفظ الماضي، بل إلى التدخل في التاريخ نفسه، لضمان ألا يكون الفن السوري ذاكرة فحسب، بل أن يُبعث من جديد—ليس كنصب تذكاري للمعاناة، بل كقوة تحوّل لا نهائية.
واليوم، ونحن نقف على أعتاب سوريا الجديدة، لا أرى هذا اللحظة كختام للنضال، بل كبداية لأفق جديد. إن كان العقد الماضي قد تمحور حول البقاء، فإن العقد القادم يجب أن يبنى على الإبداع. وإن كانت الثورة قد تطلّبت التحدي، فإن الحرية تستدعي الجمال.
لقد استقّر الغبار، وكُسر الصمت، وعلينا الآن أن نصيغ لغة بصرية جديدة—لغة لا تطاردها أشباح الدمار، بل ينيرها الفعل الجمالي المحض والراسخ في الوجود والإنسانية.
هذا ليس استرجاعًا للماضي. إنه بيان. إنه سجل لثورة في التنسيق الفني، وشهادة على عقد رفض فيه الفن الاستسلام.
” سوريا فضاء ثالث ” (2011 – 2015): فن بلا حدود، وهوية بلا قيود
المنفى جرح، لكنه أيضًا اتساع. إنه الاقتلاع القسري من الأرض، لكنه في ذات الوقت إمكانية جذرية لإعادة تشكيل الذات خارج
هندسة القمع. ومن هذا التناقض ولِد معرض “سوريا فضاء ثالث”.
حملت أولى موجات النزوح السوري معها ليس فقط الأجساد، بل سؤالًا وجوديًا: أين تستقر الهوية عندما يُسلب الوطن؟ طالبنا العالم بأن نعرّف أنفسنا من خلال الغياب، والحنين، والخسارة. رفضت ذلك.
لم يكن “الفضاء الثالث” مرثية للوطن، بل خارطة للممكن—فضاء مفاهيمي غير مقيّد بالحدود، حيث يمكن للفنانين السوريين أن يخلقوا تعبيرات جديدة متحررة من طغيان الحنين أو استجداء شفقة الغريب.
لم يكن الأمر يتعلق بعرض ‘المنفى’ ، بل بتحويل المنفى إلى فعل فني.
في جوهرها، وُلدت فكرة “الفنان المواطن”—من القوة الإبداعية التي لم يعد انتماؤها مرتبطًا بالجغرافيا، بل بالوكالة الفنية نفسها.
ضم المعرض 35 عملًا فنيًا، تحدّى كلٌّ منها فكرة سوريا ككيان ثابت، وبدلًا من ذلك، قدّمها كأمة فنية متحولة، تعبر القارات من خلال اللون والصوت والصورة.
اقرأ المزيد
“سوريا: فضاء سادس” (2017): منصّة بدوية، وحرية بلا جذور
إذا كان “الفضاء الثالث” يتعلق ببناء وطن فني يتجاوز الحدود المادية، فإن “الفضاء السادس” كان عن رفض الحاجة إلى الأرض من الأساس. كانت ثورة متحركة، وانتفاضتي كقيّمة فنيّة رفضت الثبات والجمود.
لم أتصوره كمعرض، ولا كصالة عرض، بل كتيار من المقاومة الجمالية—فضاء لا يوجد إلا في لحظات تشكّله، رفضًا لاحتواء الثورة داخل الأرشيفات أو الإطارات الثابتة. إذا كانت الثورة تتحرك، فعلى الفن أن يتحرك معها.
كان هذا الشكل من التنسيق الفني شكلاً يشبه الهجرة، كان اضطرابًا، كان رفضًا لأن يتم الاستيلاء عليه من قبل المؤسسات، والمتاحف، والقوى التي سعت لتحويل الفن السوري إلى مجرد أثر من آثار الحرب.
اقرأ المزيد
“كشاش” (2017): السماء فضاءٌ ثورّي
في دمشق طفولتي، كانت أسطح المنازل عوالم شعرية. كانت ملكًا للكشاشين—حراس الحمام—رجال أطلقوا أسرابهم تحلق فوق المدينة، كل طائر شهادة على التحليق وعلى الحرية وعلى العودة.
لكن عندما اندلعت الحرب، تحولت الأسطح إلى مواقع إعدام. الحمام، كما الناس، أُسقط من السماء. سُرقت السماء.
كشاش” كان فعلي لاستعادتها. إذا كان النظام قد عسكر الأجواء، فإن الفن سيعيد تجريدها من السلاح. عبر التركيبات البصرية، والفيديو، والصوت، طرح المعرض السؤال: من يملك السماء؟ من يتحكم في الحركة؟ ماذا يعني أن تعيش في عالم يُمنع فيه حتى الطائر من التحليق؟ وتصبح فيه الأسطح
على مستوى الأرض؟
لم يكن “كشاش” مجرد تصوير للتهجير—بل كان تجسيدًا لرفضه. بتحوّيل فعل الطيران إلى تمرّد، إلى ثورة ضد الجاذبية نفسها.
في قلب “كشاش” تأملٌ في “علاقة علم أحياء بالحرية”—أي بفكرة أن التحليق، والهجرة، والحركة لا تخص البشر وحدهم، بل كل الكائنات الحية. لم يكن الحفاظ على تربية الحمام مجرد تكريم لتقليد مهدد بالاندثار، بل تأكيدًا على أن الحرية، بجميع أشكالها، يجب أن تتم حمايتها كتراث غير ماديّ.
اقرأ المزيد
“تراب” (2018): الغبار، وجماليات الغياب
إذا كان “كشاش” قد استعاد السماء، فإن “تراب” عاد إلى الأرض—إلى غبار الدمار، إلى رمال الدفن، إلى المادة الخام لمدينة تحولت إلى صمت بفعل القصف.
بنيتُ فضاءً للنفي. صندوقًا رماديًا، فراغًا، صالة عرض مطلية بمادة المحو نفسها. لا إطارات. لا جدران. فقط غبار—يرسو، يتناثر، يتنفس. تحول فضاء المعرض نفسه إلى فراغ رمادي، مشهد حيث أصبح الغياب هو الجمالية المهيمنة.
لم يكن “تراب” يمثل الخسارة—بل كان هو الخسارة ذاتها. أجبر الجمهور على مواجهة واقع الإبادة—المدن التي تحولت إلى أنقاض، الأجساد المدفونة تحت الركام، ثقل الذكرى العالقة في جزيئات الغبار.
ولكن، أبعد من التجسيد المباشر للحرب والدمار، كان “تراب” أيضًا مواجهة مع اقتصاديات الوقود الأحفوري والدمار البيئي. الغبار الذي غطى المعرض لم يكن مجرد استعارة للحرب—بل كان بقايا مادية لنظام كامل مبني على الاستغلال والاستنزاف.
كما تفتك آلات الحرب بالمدن، محوّلة المنازل إلى أنقاض، ينهب قطاع الوقود الأحفوري الأرض، تاركًا مناظر طبيعية غير قابلة للعيش. في هذا السياق، كان “تراب” تأملًا في العلاقة العميقة بين الاستبداد، والحرب، والخراب البيئي—كيف تغذي الصراعات استغلال الموارد، وكيف يكون الدمار البشري والبيئي وجهان لعملة واحدة في الأنظمة الاقتصادية الوحشية نفسها.
الغبار هو الرابط المشترك—سواء كان غبار المباني المنهارة أو غبار الوقود الأحفوري المحترق. في هذا الفعل الفني، كشف المعرض عن العنف الخفي للحرب خارج ساحة المعركة—العنف البطيء المتواصل لاستنزاف الموارد، والتهجير، والتدمير البيئي.
ومع ذلك، حتى داخل هذا الغبار، كان هناك حركة—جزيئات تطفو، تتحول، ترفض أن تستقر. لم يكن “تراب” جنازة. بل كان استدعاءً وكان يقظة.
البيت الدمشقي: ملاذ الذاكرة والإبداع في المنفى
مشروع “البيت الدمشقي”، الذي تم تطويره
بالتعاون مع برنامج التوعية لمؤسسة “الجبل الأزرق”، جلب التراث المعماري والفني الغني لسوريا إلى الأطفال اللاجئين في مخيمي الزعتري والأزرق في الأردن. مستندًا إلى فكرة أن الهوية الثقافية تتجاوز الحدود، أعاد المعرض تخيل البيت الدمشقي التقليدي—ليس كذكرى مفقودة، بل كمساحة حية للذاكرة والتعبير الإبداعي واللعب.
من خلال سلسلة من الورش التفاعلية، انخرط الأطفال في فنون الحفر على الخشب، والخط العربي، ورسم البلاط، ورواية القصص، مستلهمين من الحرف الدمشقية العريقة. لم يكن هذا المشروع مجرد مبادرة تعليمية؛ بل كان فعل مقاومة ثقافية ضد المحو القسري، مقدّمًا للأطفال السوريين في خيام اللجوء وسيلة لاستعادة تراثهم، وإعادة تخيّل منازلهم، وكتابة سردياتهم ضمن القصة المستمرة لسوريا.
في قلب التهجير، وقف “البيت الدمشقي” شاهدًا على أن الوطن ليس مجرد مكان خسرناه في المنفى —بل هو ذاكرة نحملها، وبيت يُبنى من جديد عبر الفن والذكرى وفعل الإبداع.
موجة: إعلان نسوي
في إطار عملي كقيّمة فنية خلال سنوات الثورة السورية، يقف معرض موجة (WAVE) كمعرض محوري بالنسبة لي —يمزج بين الفن والرؤية السياسية، محولًا الإبداع إلى فعل نضالي. تم تنسيقه بالتزامن مع المؤتمر العام الرابع للحركة السياسية للنساء السوريات (SWPM)، ليكون أكثر من مجرد معرض؛ بل وثيقة حية للمقاومة النسوية، ومساحة تُسجل فيها نضالات النساء السوريات وانتصاراتهن وقيادتهن في صفحات التاريخ.
من خلال أقسامه الثلاثة—“رسائلهن”، “لحظاتهن”، و”وجوههن”—يعيد موجة بناء السردية الثورية من منظور نسوي. يتحدى الإقصاء السياسي، ويفكك السرديات المهيمنة، ويؤكد أن النساء السوريات لسن مجرد هوامش في الثورة، بل هن معمارها وحامياتها. يعكس المعرض حراك المقاومة—فكما تتحرك الأمواج، شهدت المشاركة السياسية للنساء السوريات صعودًا وانكسارًا وإعادة تشكّل، لكنها لم تتوقف قط.
كقيّمة فنية ملتزمة سياسيًا ومديرة تنفيذية لـSWPM منذ عام ٢٠١٩ أعمل عند تقاطعية الناشطية الثقافية والنضال النسوي، لضمان أن يكون الفن ليس مجرد انعكاس للتاريخ، بل قوة فاعلة في تشكيله.
هذا المعرض جزء من التزامي الأوسع: انني لست فقط قيّمة أعمال فنية، بل أسعى لتنسيق الحركات النضالية أيضاً. وأقوم بذلك من خلال تحدّي التهميش، وإعادة تصور الفاعلية، والتأكد من أن الطاقة الثورية للنساء السوريات تُوثَّق ويحتفى بها وتُحمّل إلى الأمام. موجة ليس مجرد انعكاس للماضي—بل تيار فاعل، وقوة ستواصل تشكيل المستقبل.
التنسيق الفني كفعل مقاومة: الربيع العربي واستعادة المساحات العامة عبر الفنون
لم تكن الانتفاضات التي اجتاحت العالم العربي منذ 2011—من تونس إلى سوريا، ومن مصر إلى لبنان—ثورات سياسية فحسب، بل كانت أيضًا لحظات يقظة ثقافية. أعادت هذه الحركات تشكيل دور الفضاء العام، والذاكرة، والمقاومة الفنية، متحدية الهياكل السلطوية التي تحكم المؤسسات الثقافية، بل حتى دور القيم الفني ذاته.
لم أكن مجرد شاهدة على الربيع العربي—كنت جزءًا منه. بصفتي المديرة الاقليمية لبرامج الفنون في المجلس الثقافي البريطاني بين عامي 2011 و2016، كنت في قلب الساحات الثورية، حيث لم يكن الفن مجرد ديكوراً للاحتجاج، بل كان نبضه، مستعيدًا الفضاء والصوت والوكالة.
من ميدان التحرير إلى شارع الحبيب بورقيبة، ومن ساحة رياض الصلح إلى ساحة المرجة، رأيت بعيني كيف تجاوز الإبداع القمع، محوّلًا الجدران إلى بيانات سياسية، والأداءات الفنية إلى أفعال تحدٍّ.
لم يكن الفن في تلك اللحظات ترفًا، بل كان ضرورة—ووسيلة للبقاء، واستعادة للكرامة، ورؤية لما يكمن خلف المتاريس. كنت ملتزمة بدعم الأصوات الناشئة التي تناضل في ظل المنفى والرقابة، لضمان استمرار تعبيراتها بعد زوال لحظة الثورة الآنيّة. لم تشكّل هذه التجربة ممارستي الفنية فحسب—بل صاغتها، مؤكدةً إيماني بأن الفن ليس مجرد انعكاس للتاريخ، بل هو أداة في صناعته، قوة تتحدى، تشفي، وتعيد تخيل الممكن.
تجلّت هذه التحولات الجذرية بوضوح خلال انتفاضة لبنان في 17 أكتوبر 2019، حيث لم يكن الفن مجرد شكل من أشكال الاحتجاج، بل كان تدخّلًا سياسيًا مباشرًا.
من الجدران المغطاة بالغرافيتي إلى الأداءات الفنية التي استعادت الشوارع والجسور، ومن الهتافات الجماعية إلى التركيبات الفنية الميدانية، تحولت بيروت إلى لوحة حيّة تتنفس العصيان.
إحدى أكثر اللحظات إثارة كانت احتلال “البيضة”—السينما الب brutalist المهجورة، أثر من الحرب الأهلية اللبنانية، ورمز لخصخصة بيروت من قبل شركة سوليدير. استولى الفنانون والطلاب والنشطاء على الفضاء، محوّلينه إلى منتدى مفتوح للمقاومة الفنية والسياسية. الشعارات التي كُتبت على جدرانه المشوهة بالرصاص جسّدت طموحات الثورة الجذرية:
“يسقط النظام.”
“الثورة لن تكون منظمة.”
“يسقط الفن المعاصر.”
كان رفض “الفن المعاصر” في الواقع رفضًا للوصاية الثقافية. وكان تمرّدًا ضد دور القيّم الفني كوسيط للسلطة، وضد الهياكل التي تتحكم في الإنتاج الثقافي وتحدد ما يُعرض، ومن يُسمح له أن يُسمَع.
وصلتُ إلى بيروت ليس كقيّمة فنيّة، بل كمشاركة في شارع الثورة. ومع ذلك، أثناء مشاركتي في هذه النقاشات، أدركت أن مهنتي ذاتها كانت قيد المحاكمة.
ماذا يعني أن تنسّق معرضًا في زمن الثورة؟ هل ينبغي للقيم أن يتنحى جانبًا، أم أن له دورًا ليؤديه؟ هل يمكن للفن أن يبقى مستقلًا، أم يجب أن يكون جزءًا من النضال؟
كانت إجابتي فعل محوٍ للذات. وقبل مغادرتي بيروت، أخذت علبة طلاء ورششت على جدران البيضة: “يسقط القيم الفني.”
من المقاومة إلى الجماليات: مستقبل يتجاوز البقاء
على مدى عقد من الزمن، كان تنسيقي الفني نضالًا ضد الإختفاء، ضد الصمت، ضد ثقل النسيان القسري.
لكن الآن، مع تنفّس سوريا للحرية، أرفض أن يظل فني محصورًا في مفردات الدمار. الثورة لا تنتهي عند النجاة، بل يجب أن تتجه نحو الجمال.
لا أريد لفّني أن يكون مقيداً بالذاكرة المؤلمة، بل أريده أن يكون مرتبطًا بالسموّ.
لأن الفّن هو فعل خلق، والخلق هو فعل حلم.
والمستقبل ينتمي لأولئك الذين يجرؤون على الحلم بشجاعة.